""والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ونظرة على دور العقل في اكتساب المعرفة من ديكارت إلى كانط"
الايمان بالله يتتطلب المعرفة ليس فقط بالوجدان ولكن أيضا بالنقل مع العقل. فهل أيضا تتطلب المعرفة بالناس وبالكون حولنا إلي العقل فقط أم كلا من العقل والوجدان. وإذا كانت المعرفة هي العامل المشترك، فهل تتطلب العقل أولا ثم الحواس، أم الحواس أولا تم العقل، أم تتطلب كلاهما متزامنين. وإذا كان المثل الشعبي يقول "الزواج نصف الدين". إلا أنى أقول في هذا المقام أن "العقل نصف الدين"، فالدين قد خاطب العقل أولًا والوجدان ثانيًا، لأن الوجدان السليم يتتطلب عقل سليم خاصة في هذا العصر الذي نحتاج بشدة فيه إلى إعمال العقل وسط لنكون قادرين علي خوض السباق في التنافس العلمي والمعرفي المعلوماتي والتكنولوجي.
وقد أشار الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة إلى حتمية إعمال العقل وما يتطلب ذلك من عمليات التأمل، والتدبر، والتفكر، كتكليف للمؤمنين لاستخدام العقل في فهم النقل. وليس أدل على ذلك أن أول آيات القرآن الكريم(من 1-5 من سورة العلق) "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) التي تنزلت على رسول الله محمد كانت عن القراءة، والكتابة والعلم، والمعرفة وكلها عمليات عقلية تتطلب إعمال العقل بكل صوره، سواء العقل الظاهر (الواعي) أو الباطن (اللاواعي).
وقد توقفت كثيرًا عند الآية الكريمة رقم ٧٨ من سورة النحل"﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لارتباطها الظاهر بنظرية المعرفة وبفلسفة (حب الحكمة) العقل التي شغلت تفكير الفلاسفة منذ قرون بعيدة. فعندما سمعت هذه الآية الكريمة كنت، وبالصدفة البحتة، قد أنهيت على التو قراءة مقالين عن نظرة فلاسفة عصر النهضة لدور العقل في الفهم البشري والعلم الحديث. وعندما قرأت التفسيرات المختلفة لهذه الآية وجدتها وقد اجتمعت على المفهوم الظاهر وهو ولادة الإنسان بعقل أبيض بمعني خالي من كل المعلومات (لا تعلمون شيئا...).
وهنا انتابني سؤالا مهما وهو "هل تعني الآية أيضا أن العقل البشري يولد وليس به أي أفكار فطرية قِبلية (قبل الولادة)، أم أن المقصود هو العلم وليست المعلومات الأساسية؟ وسواء كان المقصود من الآية ولادة عقل خالي من المعلومات الأساسية/العميقة أو العميقة فقط، فإن ظاهر الآية يبين أن عقل الإنسان يبدأ في اكتساب معرفته فور ولادته من خلال استعمال حواسه الخمس وتفاعلها مع بيئته الداخلية (مشاعره وأحاسيسه وأفكاره الذاتية) وبيئته الخارجية بكل مكوناتها مما يدل دلالة مباشرة على ماهية العقل حديث الولادة وعلاقته بنظرية المعرفة وفلسفة العلم الذي يكتسبه مع مراحل العمر من بيئته الخارجية التي بالطبع تؤثر في بيئته الداخلية البيولوجية المكودة في الجينوم.
وبقراءة العقل عند فلاسفة عصر النهضة، وخاصة الفرنسي "رينيه ""ديكارت"، والإنجليزي "جون لوك"، والأسكتلندي "دفيد هيوم"، والإنجليزي "إيمانويل كانط" فقد آثرت أن أذكر هنا نظرياتهم فمنهم من اتفقت فلسفته أو اختلفت مع ما يُعبر عنه ظاهر هذه الآية الكريمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالي حوالي ٧٠٠ عام قبل ولادة هؤلاء الفلاسفة الكبار. وقبل أن أعرض رؤية هؤلاء الفلاسفة الأربعة عن ماهية العقل قبل وبعد الولادة ودوره في اكتساب المعرفة وفي فلسفة العلم، دعوني أقدم أولًا أهمية نظرية المعرفة التي تتطلب إعمال العقل لمعرفة الإنسان لذاته ومن حوله من الناس والكون. وبسبب هذا العقل البشري رفيع المستوي حاول الفلاسفة (المفكرون) من فهمه والتعرف عليه حتى وصل الأمر إلى صياغة نظرية المعرفة Epistemology
وقد مر تعريف العقل عند الفلاسفة والمفكرون عبر العصور والحضارات المختلفة بمراحل كثيرة. وكان الفلاسفة الإغريق (اليونانيون) مثل بـطاليس، ثم سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، هم أكثر الفلاسفة الذين تناولوا قضية العقل، ولكن من جانب نظري ومثالي بعيدًا عن الواقعية، إلا أن أفكارهم أظهرت أهمية العقل في تشكيل الفكر الإنساني. وقد ظلت هذه النظرة في التعامل مع العقل النظري سارية لقرون طويلة (حوالي ٢٠٠٠ عام) حتى عصر النهضة الأوروبيّة منذ بداية القرن السادس عشر عندما تحول العقل من مجرد أداة للفهم إلى موضوع بذاته وبمكوناته يحتاج للدراسة للوقوف على دوره في الحياة عموما وفي العلم (فلسفة العلم) خاصة. وقد أطلق على هذا التحول في النظر إلى العقل بعصر الحداثة وذلك لأن الفلاسفة تحرروا فيه من النظرة القديمة من استخدامه كأداة إلى موضوع يتم دراسته بعمق.
وكان من أوائل فلاسفة عصر النهضة الذين بدئوا في إعادة النظر في مفهوم العقل والتعرف على ماهيته (أي طبيعته) هو الفيلسوف وعالم الرياضيات والفلكي الفرنسي "رينيه ديكارت" (١٥٩٦ - ١٦٥٠م) والذي أسس المدرسة العقلانية التي ترتكز على أن العقل هو أساس كل مدخلات ومخرجات النفس البشرية من مشاعر، وأحاسيس، وانفعالات، وقرارات. فقد كان ديكارت يؤمن بأن الإنسان يولد وعقله مزود بمجموعة من الأفكار الفطرية (القِبلية) كافية وبدون الحواس لمعرفة الله ولإدراك الكون. وقد دعم شك ديكارت هذا في حقيقة ما تتعرف عليه الحواس تأثرًه بنظرية العالم الفلكي البولندي "نيكولاس كوبرنيكوس" (١٤٧٣ - ١٥٤٣م) عن مركزية الشمس للكون بدلًا من الأرض، والتي أثبت فيها أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس كما كان يعتقد الجميع منذ أرسطو ولأكثر من ٢٠٠٠ عام. وبهذا نجد أن نظرة ديكارت للعقل مخالفة لظاهر الآية الكريمة من سورة النحل"﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.
وقد تزامنت عقلانية ديكارت هذه مع طرح رجل القضاء والسياسي والفيلسوف الفرنسي "فرانسيس بيكون" (١٥٦١ - ١٦٢٦م) - الذي عاصر ديكارت – حيث كان العقل يمثل له محور التفكير مما دعاه يؤلف كتابًا بعنوان "الأورجانون - أي القانون - الجديد مقابل كتاب الأورجانون لأرسطو" الذي نشر فيه أطروحته عن حتمية التخلص من الأوهام الأربعة قبل تناول العقل لأي موضع للبحث. وتلك الأوهام هي:
1- وهم القبيلة أو الجنس: ويشمل المعتقدات التي يؤمن بها معظم الناس بغض النظر عن موضوعية هذه المعتقدات.
2- وهم الكهف: ويشمل المعتقدات الشخصية التي يكتسبها الانسان من بيئته بما فيها الصالح والطالح والتي قد تشوش التفكير، وهذا الوهم استمده "فرانسيس بيكون" من قصة الكهف المعروفة لأفلاطون والتي ذكرها في كتابه "الجمهورية".
3- وهم السوق: والمقصود به اختلاف اللغة وتباين معاني الألفاظ والمصطلحات من مجتمع لآخر ومن شخص لآخر مما قد يعطي معاني مختلفة أو متضادة.
4- وهم المسرح: والمقصود به انسياق الانسان وراء الآخرين كقدوة أو مثل بغض النظر عن طبيعة أفكارهم وتقليد افكارهم تقليدا أعمي.
وفي زمن ديكارت ظهر الفيلسوف الإنجليزي "جون لوك" (١٦٣٢ - ١٧٠٤م) والذي نقد هذه النظرة العقلانية والأفكار القِبلية لديكارت ليقدم أطروحته بأن العقل يولد بلا أي أفكار فطرية (عقل زيرو أي عقل أبيض) وبأن الحواس هي أساس كل القرارات العقلية وبدونها لا معنى للعقل، وبأن دور العقل يأتي بعد عمل الحواس وبهذا نجد أن طرح جون لوك يتوافق مع ظاهر الآية الكريمة من سورة النحل وذلك على عكس طرْح ديكارت. وقد مهدت أطروحة "جون لوك" إلى تأسيس المدرسة التجريبية التي تؤمن بأهمية التجربة من خلال الحواس لكي يدرك العقل بيئته الداخلية والخارجية ويخرج بأفكاره.
وبعد وفاة جون لوك بسبع سنوات ولد الفيلسوف الاسكتلنديّ "ديفيد هيوم" (١٧١١ - ١٧٧٦م) والذي كان مؤمنًا بنظرة "جون لوك" وداعما لها وبدور الحواس قبل العقل، ولكنه جمع بينها وبين عقلانية ديكارت ليوطد ويمكن للمدرسة التجريبية التي تقر بحتمية التجربة المبنية على الحواس مع أهمية العقل في تفسير نتائج التجارب والخروج منها بقوانين ومعادلات يستخدمها العقل نفسه بعد ذلك في إدراك وفهم الظواهر الكونية والنفس البشرية.
ثم حدثت نقلت نوعية في نفس الفترة الزمنية لديفيد هيوم عندما ظهر الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط" (١٧٢٤ - ١٨٠٤م) والذي جمع المدرسة العقلانية (لديكارت) والتجريبية (لجون لوك وديفيد هيوم) في منهج واحد لتكتمل نظرية المعرفة ويحدد فيها الدور المتكامل لكلا من العقل والحواس ودور التجربة في منظومة متكاملة تبدأ بالإدراك بالحواس المرتبطة تشريحيا بالدماغ وخاصة السمع ثم البصر ثم باقي الحواس، ثم دور العقل بما لديه من بعض المقولات القِبلية (قبل الولادة) ليُصهر ما تنقله الحواس وما توصلت إليه التجربة في بوتقة واحدة تسمي المعرفة وذلك من خلال أربع خطوات متتالية هي؛
1- الحدس: استقبال المؤثرات الخارجية بالحواس ووعيها كما هي بدون أي تحليلات،
2- التحليل والتفكيك: تفكيك الموضوع الكلي كقضية أساسية إلى أجزاء صغيرة سهلة الفهم.
3- التركيب: اعادة تجميع وتركيب كل ما تم تحليله وتفكيكه وفهمه من الأجزاء الصغيرة منفردة ليكون الموضع الكلي مرة أخرى.
4- المراجعة: مراجعة ما توصل اليه العقل من اعادة التركيب مع اجراء العمليات الاحصائية التي تعطي خلاصة دقيقة محسوبة ممكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج.
وبهذا نرى أن ديكارت كان يؤمن بأن الإنسان يولد وعقله مزود بمقولات قِبلية (أفكار فطرية) تمكنه من فهم الظواهر الكونية الظاهرة والباطنة والتي تجعله يؤمن بالله. أما جون لوك فقد قدم الحواس على العقل حيث كان يؤمن بأن الإنسان يولد بعقل أبيض ليس به أي أفكار أو معلومات مسبقة. وأيده في ذلك ديفيد هيوم، ثم كانط الذي جمع رؤية ديكارت وديفيد هيوم وجون لوك سويا مؤمنًا بأن الإنسان يولد وبعقله بعض الأفكار القِبلية البسيطة التي تمكنه من تعظيم الاستفادة من رد فعل الحواس ليكتسب مع الوقت معرفة تمكنه من فهم العالم حوله وفهم الدين بالعقل والوجدان والأخلاق حتى أن مقولاته عن الأخلاق (كقانون عقلي) أصبحت أساس العديد من الدساتير ومواد حقوق الإنسان.
ولست أدري ما إذا كان هؤلاء الفلاسفة قد قرأوا الآية رقم ٦٨ من سورة النحل (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وما إذا كانوا قد اضطلعوا على ماهية العقل لدى الفلاسفة المسلمون وأهمهم الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، والغزالي، ودراساتهم لأنواع ورتب العقل ودوره في معرفة الله والكون من خلال نظرة إسلامية، ولكنها متأثرة بفلسفة أرسطو. ولكني أعتقد والله أعلم أن ما توصل إليه "إيمانويل كانط" من أهمية العقل والحواس في اكتساب العلم والمعرفة يتفق من ناحية مع المعني الظاهر للآية الكريمة ومن ناحية أخري مع معني آخر قد يكون باطنا فيها. فمع أن ظاهر هذه الآية يشير إلى أن الإنسان يولد بعقل أبيض (أي بلا أي معلومات أو علم)، إلا أن هذا المعني الظاهر قد يكون المقصود به العلم في مجمله (لا تعلمون شيئًا) وهو الأمر الذي لا بد من اكتسابه كما في طرح "جون لوك" و "ديفيد هيوم".
وهذا بالطبع لا يجعلنا نستبعد أن العقل الذي يولد بالفعل أبيض (بدون علم) به بعض الأوعية المعرفية (الأسماء التي علمها الله لآدم) والتي قد يمنحها الله سبحانه وتعالى للجنين مع نفخ الروح فيه خاصة أن الدماغ بما فيه المخ (مكان العقل) هو من أول الأعضاء التي تتكون في الجنين (بعد حوالي 3 أسابيع من الإخصاب) ومن أول الأعضاء التي يكتمل نموها. وقد تحتوي هذه الأوعية المعرفية (مجازا) على الأسماء (وعلمنا آدم الأسماء كلها: البقرة ٣١) التي تمثل الأدوات الأساسية للمعرفة (المقولات القِبلية) التي تجعل المولود يشعر بالزمان والمكان والأحاسيس، والمشاعر، والفرح، والحزن، والتي بالطبع تختلف عن مفهوم العلم الذي أشار الله إليه في الآية الكريمة في قوله سبحانه (….. لا تعلمون شيئًا). والذي أعقبه بالجزء الآخر من الآية الذي يعبر عن أهمية الحواس كما كان يؤمن "جون لوك" و "ديفد هيوم" (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). وقد أنهي الله هذه الآية بكلمة لعلهم "يشكرون" إشارة منه للناس علي نعمة اعطائهم الفرصة كاملة لاكتساب العلم والمعرفة بعد خروجهم من رحم أمهاتهم كُلٍ بطريقته ومنهاجه بعد أن بين لهم المنهاج المرجعي من خلال الأنبياء والرسل.
وفي نهاية هذا الطرح، أرى، والله أعلم، أن هذه الآية الكريمة قد تعني أن الله يخرج عباده من أرحام أمهاتهم بدون علم أو معرفة معبأة مسبقًا في عقولهم تجعلهم مبرمجين ومسيرين، ولكن أعطاهم فقط بعض المقولات القِبلية التي تمكنهم لاحقًا بعد الولادة من وعي الزمان والمكان واللغة والمشاعر من حزن وفرح وألم حتى وإن كان المولود لا يعلم ما هو الفرح وما هو الحزن وما هو الألم وما هو الزمان ولا المكان الذي يعيش فيه. ومن مفهومي الشخصي أيضا أن الدليل على ولادة الإنسان بهذه المقولات القِبلية التي تسري في أوعيته العقلية (كما البلازما في الدم) هو بدء الطفل في الصراخ أو البكاء فور ولادته ثم بعد ذلك بأيام وأحيانا ساعات حيث نرى ردود أفعاله من غضب وسعادة وشعور بالألم وغيرها من المشاعر الفطرية التي لا تندرج تحت تعريف العلم.
كما أتمنى من خلال هذا الطرح أن أكون قد بينت معني الآية بناء على مفهوم واجتهاد شخصي، وأن أكون قد طرحت مفهوم العقل عند هؤلاء الفلاسفة الأربعة خاصة ومدي توافقهم أو اختلافهم مع مفهوم الآية الكريمة. ورغم أن البعض قد يري أن هذا الطرح مع رؤية هؤلاء الفلاسفة للعقل من خلال مفهوم الآية ليس مهمًا في حد ذاته، إلا أني أراه مهما للأسباب الآتية:
- قد يكون أسلوبًا جديدًا لفهم الآية من منظور جديد (في حالة كونه اجتهادًا صائبا) من ناحية، وفي تقديم مفهوم العقل عند هؤلاء الفلاسفة من ناحية أخري.
- أهمية الحفاظ على الأوعية الفكرية القبلية المكودة في العقل قبل الولادة خاصة أن الأبحاث الحديثة بينت أن توفر بعض المواد الغذائية مثل فيتامين د مهمة للغاية للنمو العقلي بعد الولادة وتحقيق مستوي عالي من IQ الذكاء.
- أهمية الحفاظ على صحة الم والطفل بعد الولادة من خلال تغذية وبيئة نفسية صحية لأن الصحة العقلية للطفل تتشكل تحت تأثير هذه الظروف.
- ضرورة تعظيم الاستفادة من الحواس الخمس عند الأطفال حديثي الولادة وخاصة السمع والبصر ومعهما الفؤاد والتي ذكرها الله في الآية الكريمة لأهميتهما في تحقيق معرفة صحية بناءة.
- تسليط الضوء على قضية اعمال العقل التي اهتم بها القرآن اهتمامًا كبيرًا حتى جعل التفكير في آيات الله في النفس ذاتها وفي الكون فرض عين على كل مؤمن.
وفي هذا المقام، لا بد من الإشارة إلى أن التقدم الهائل في العلوم العصبية والذي كشف عن مناطق محددة في دماغ الجنين مسئولة عن الذاكرة والمعرفة (على سبيل المثال منطقة الحصين) والعدد الهائل من التشابكات العصبية التي تحدث مباشرة بين الخلايا العصبية بالدماغ كلما تلقي الأخير اثارة دماغية بعد الولادة، والذي بالطبع قد يحدث كذلك قبل الولادة. وقد اكتشف العلماء أيضا أن العقل الميتافيزيقي يتأثر ويؤثر في العقل الفيزيقي (الدماغ). ومن يدري، فقد يثبت العلم في المستقبل ان العقل جزء لا يتجزأ من الدماغ له مكان تشريحي داخل الدماغ وليس مجرد حالة ميتافيزيقية.
كم أحوجنا في هذا العصر أن نجعل قضية اعمال العقل محور تفكيرنا لفهم الدين ولفهم أنفسنا والآخرين وفي المنافسة في العلم والمعرفة بنظرة عقلانية بعيدة عن الأساطير والخرافات التي ضيعت العقل وجعلته لقمة سائغة لكل غاصب للهوية. فإعمال العقل هو الضامن الأكبر للمناعة الدينية، والعلمية، والمعرفية، والنفسية، والثقافية، والتراثية للشعوب.
ملحوظة:
هذا المقال لا يمثل تفسيرا أو رأيا دينيا، فما هو إلا مفهوما شخصيا اجتهدت فيه ولعلي أكون أصبت، والله المستعان.
بقلم ا.د. محمد لبيب سالم
أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا
وكاتب وروائي وعضو اتحاد كتاب مصر
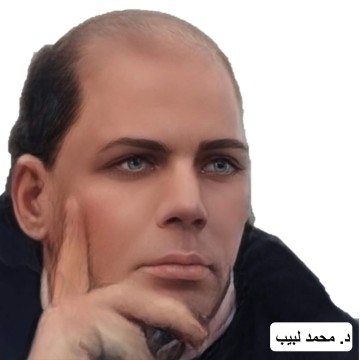
















التعليقات