"إذا كان الفيلسوف وعالم الرياضيات والفلك الفرنسي رينيه ديكارت قال قولته المشهورة أنا أشك، إذًا أنا موجود، فأنا أقول: أنا أقرأ، إذًا أنا موجود"
الكتاب الوحيد الذي عرفته ولمسته وقرأته خارج الكتب المدرسية وأنا طفل هو كتاب الله "القرآن الكريم" الذي كنا نُطلق ونحن أطفال المصحف. نعم، هذا هو الكتاب غير المدرسي الوحيد الذي عرفه جيلي الريفي ونحن أطفال من خلال المساجد والبيوت. حتى هذا الكتاب غير المدرسي حفظناه ونحن صغار في الكتاتيب قبل دخول المدرسة عن ظهر قلب وليس عن فهم.
فما عدا المصحف، لم نكن نعرف في حياتنا سوى الكتب المدرسية عندما شاء القدر وكتب لنا دخول المدرسة الابتدائية . ولم تخرج الكتب المدرسية عن بعض المواضيع البسيطة جدًا عبارة عن دروس في الأدب وحب القراءة وغيرها على غرار "أمل وعمر" وأبلة "سعاد". وهكذا تربي جيلي طوال فترة ما قبل المدرسة (الكُتاب) والابتدائية على المصحف (كحفظ) والكتب المدرسية كقراءة مدرسية. ولم يكن لدينا أي نوافذ أخرى في القرية نتعلم منها، فكان الكتاب المدرسي، والمدرس، وتعليمات الاسرة هي كل مصادر المعرفة. وبعض المحظوظين كان لديهم راديو، وبالطبع لم تعرف معظم القرى في جيلي الكهرباء وبالتالي لم تعرف التليفزيون حتى الأبيض والأسود إلا ونحن في الإعدادية.
هذا هو الحال الذي كانت عليه القرية في الماضي، لا تلفاز، لا كهرباء، لا مكتبات عامة، لا جرائد، لا مجلات، لا شيء سوى الكتب المدرسية، والمدرس، والآباء والأمهات اللذين في الغالب كانوا أميين. نعم، كانت مصادر المعرفة محدودة جدًا، وبالتالي كان النمو العقلي لنا يعتمد على الخيال الخصب وعلى محاولات الابتكار البسيطة التي كنا نتسلى بها وبما في ذلك من فروقات فردية.
وعندما كبرنا وانتقلنا إلى المدرسة الإعدادية في المدينة، أدركنا أن هناك مكتبات في المدارس، ومكتبات عامة، ومراكز ثقافية ممكن أن نستعير منها كتبًا ومجلات ونحتفظ بها معنا في المنزل لنقرأها على راحتنا لمدة أسبوع ومجانًا. ساعتها، تعجبت من وجود نظام مثل هذا ولم نكن نعلمه نحن الطلاب في الريف. صحيح، لم يكن كثير من زملائي يذهبون إلى المكتبة لاستعارة الكتب، ولكن كانت هذه الخدمة المعرفية لمن يحب القراءة خدمة كبيرة كمصدر للمعرفة لم نكن حتى لنتخيلها.
ولن أنس أول رواية قرأتها للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، والذي لم أكن أعرف من هو، ولا كنت حتى سمعت عنه، ولم أكن أعرف الفرق بين القصة، والرواية، والكتاب والمقال. ولو كان أحدٌ سألني أيامها عن العقاد، أو طه حسين، أو المازني، أو المنفلوطي، أو احسان عبد القدوس، أو توفيق الحكيم، أو أنيس منصور، أو يوسف ادريس، أو الرافعي لما عرفت أي منهم أو غيرهم، طالما لم يكونوا مقررين في الكتب المدرسية. أما بعد اكتشافنا للمكتبات العامة فقد أصبحنا نقرأ لهؤلاء رويدًا رويدًا ثم بنعم حتى ونحن لا نعرف من هم.
تلك كانت حياتنا الثقافية آنذاك، لا نعرف إلا ما هو مقرر علينا، وما يقوله لنا المدرسون، وما نسمعه في الراديو، وما نقرأه صدفة في كتاب استعرناه من المكتبة ولا نعرف عنه شيئا إلا بعد أن نقرأه، في وقت لم يكن هناك إنترنيت ولا شبكات التواصل الاجتماعي. نعم، تلك كانت مصادر المعرفة لنا والتي تربت عليها عقولنا حتى كبرنا. وبالطبع، ازدادت وتنوعت مصادر المعرفة من كل اتجاه حتى أصبح لدينا نهم شديد لكل مصدر منها حتى نعوض ما فات من حرمان معرفي.
وقد يسأل سائل، ولماذا هذا الحديث الآن، وهذه أمور معروفة عن الزمن الماضي. وأقول إن السبب وراء ما ذكرت هو ملاحظتي لضحالة مستوى الثقافة والمعرفة لدى طلاب المدارس والشباب رغم ذكائهم الشديد وحيوية أفكارهم، ورغم ما يتمتعون به من إتاحة مصادر متعددة ومجانًا لكل أنواع العلم، والمعرفة، والثقافة من كتب ومجلات، وروايات، وقصص قصيرة عربية، ومترجمة، ومسموعة، ومرئية.
لقد علمتني تجربة استعارة الكتب من المكتبة ليس فقط حب القراءة والتعرف على المبدعين، ولكن الأهم الغوص في بحور المعرفة ومعايشة تجارب الآخرين والتعلم منها مجانًا من مجرد كتاب بين يديّ. فالكتب، أيا كانت نوعية المعرفة بها، هي خلاصة العقول المبدعة التي تعطيك خلاصة لك ها من شعر، وأدب، وعلم، وقصص، وروايات، وحوارات، وسيرة ذاتية، وأدب رحلات مجانًا. والآن، ومن خلال القراءة من المصادر المفتوحة أصبحت ملما بالكثير من الأحداث التاريخية على مر العصور، وأصبحت قارئا في الفلسفة، وعلم النفس، والتاريخ، والطب، والتكنولوجيا وكلها أمور لم أكن أعرف عنها سوى ما كان مقررًا علينا في الكتب. وقد ساعدني ذلك لأعرف الفلاسفة والعلماء والمفكرون والرجال الدين. وأصبحت قادرًا على مقارنة التراث بما هو موجود، بل أصبح لي منهجي الفكري ومدرستي الفكرية، أصبحت فاعلًا في الانتاج العلمي كمحلل وكاتبًا.
الكتب هي التي كونت شخصية عقلي وشكلت وجداني، حتى أني أذكر تعلقي بشخصية بطل أحد الروايات وأنا في مرحلة الثانوية العامة، تعلمت منه المثابرة، والجدية، والصدق، والأمانة. وتعلمت من كتابات كل المبدعين حتى أن بعضهم أصبح صديقًا لي من خلال كتاباته دون أن أعرفه. فقراءة الكتب خاصة المطبوعة لها نكهة مميزة لا تضاهيها قراءة ألف كتاب على الإنترنت، لأن مع طقوس القراءة تتولد المشاعر من جميع الحواس. وأتصور أن شًح ثقافة قراءة الكتب أصبح سمة مميزة للدول العربية يا للأسف ومنذ أن أصبح الإنترنت متاحًا للجميع ومجانًا. فمعظم الشباب يعتمد على قراءة قصاصات الأخبار ومن مصادر غير موثوق فيها.
كم كنت أتمنى وأنا صغير أن يكون لدي كل هذه المصادر المتعددة والمجانية للمعرفة، كل هذه القوة الهائلة من الكتب المقروءة والمسموعة والمطبوعة والمتاحة للجميع، والتي أنهل منها كل يوم وبكل السبل حتى أعوض النقص الذي كان لدينا ونحن أطفال. فكم هو محظوظ هذا الجيل، ولكنه لا يثمن هذا الحظ لأنه لم ير ما كان من حرمان. وعن نفسي.
وعن نفسي أشعر أن لو كانت كل مصادر المعرفة هذه متاحة وأنا طفل لكانت شخصيتي تطورت أكثر وأكثر وللأفضل. ولذلك فأنا أحاول أن أسبق الزمن واضطلع على كل ما لم أستطع الاضطلاع عليه وأنا صغير بسبب ندرة مصادر المعرفة آنذاك. ففي زمنٍ تتزاحم فيه الشاشات وتتنافس فيه الومضات الرقمية على انتباه الإنسان، تقف الكتب كأثرٍ عميق من زمنٍ آخر، تنبض بالحبر لا بالضوء، وتحاور العقل لا تستهلكه. لم تكن الكتب يومًا مجرد أوراق مجلدة، بل كانت أوطانًا صغيرة تسكنها الأفكار، ومرافئ للروح في عصورٍ كان الإنسان فيها أكثر ميلًا للتأمل والسكون.
ففي فترة الثلاثينات وحتى الثمانينات، كانت الكتب تُعامل باحترام يشبه التقديس. كانت تُشترى من المكتبات كما تُشترى الهدايا، وتُتداول كما تُتداول الأسرار الثمينة. القراءة آنذاك لم تكن هواية فحسب، بل أسلوب حياة. كان الشاب العربي يفتخر بما يقرأ، ويتباهى بمعرفته لفلسفة سارتر أو نيتشه، أو لأدب طه حسين، ونجيب محفوظ، وغسان كنفاني.
لكن مع دخول القرن الحادي والعشرين، زحفت الرقمنة على كل شيء: التواصل، التجارة، التعليم، وحتى القراءة. ومع أن الرقمنة حملت معها مزايا لا يمكن إنكارها—من سهولة الوصول إلى المعلومة، إلى تنوع المحتوى وتوفره مجانًا—إلا أن هذه الإيجابيات جاءت على حساب عمق التجربة. فقد تحوّلت القراءة من طقس معرفي عميق إلى نشاط سطحي، سريع، يركّز على المعلومة لا على الفكرة، وعلى العنوان لا على المضمون. وأصبحنا أمام جيلٍ يقرأ العناوين ويتجاوز النصوص، يختار "المختصرات" بدل الفصول، ويستهلك "مقاطع ثقافية" كما يستهلك مقاطع الطبخ والمميز.
لم تعد المعرفة فعلًا عقلانيًا. لم يعد القارئ شريكًا في المعنى، بل صار مجرد مستهلك يختار من قائمة جاهزة. وكما أفسدت الوجبات السريعة أذواق الطعام، أفسدت الوجبات الفكرية السريعة أذواق العقول.
تشير التقارير والدراسات الحديثة إلى تراجع معدلات القراءة بشكل مقلق. تقرير اليونسكو لعام 2023 أشار إلى أن نسبة الشباب الذين يقرؤون كتابًا كاملًا في العام الواحد قد انخفضت بنسبة 40% مقارنةً بالتسعينات. كما وجدت دراسة من جامعة ستانفورد أن القراءة الرقمية تقلّل من قدرة الدماغ على الاستيعاب التحليلي مقارنةً بالقراءة الورقية.
الرقمنة ليست عدوًا بذاتها، لكنها حين تقتحم كل شيء وتحوّله إلى استهلاك سريع، تصبح خطرًا على التفكير، والتربية، والهوية. لا نطالب بإلغاء التكنولوجيا، بل بعقلنتها. لا نريد استبعاد الرقمنة، بل تطويعها لخدمة المعرفة لا قتلها. فالحل هو أن نعيد للقراءة هيبتها وأن تقوم المؤسسات التعليمية في العالم العربي بمسؤوليتها. فالقراءة ليست مسؤولية الفرد وحده، بل هي ركن من أركان النهضة الجماعية. وإذا كان عزوف الشباب عن الكتاب قد أصبح واقعًا مريرًا، فإن تغييره يحتاج إلى قرارات شجاعة من مؤسسات التعليم والتنشئة. ولأجل ذلك، فإننا نقترح سلسلة من الإجراءات الجادة التي ينبغي أن تُنفذ بصرامة وانتظام:
- إدراج "حصص قراءة حرة" إجبارية في كل المراحل الدراسية.
- إطلاق مسابقات للقراءة علي مستوي مصر سنوية بين المدارس والجامعات.
- تحديث مكتبات المدارس والجامعات وتوفير كتب معاصرة.
- ربط القراءة بالمناهج دون تحويلها إلى "مادة امتحانية".
- برامج تبنٍّ من المعلمين والمعلمات
نعم. لا بد وأن تطبق وزارة التربية والتعليم ما تفعله الدول الأخرى ليس فقط لتشجيع الطلاب على القراءة، بل لإجبارهم عليها. فأتذكر جيدًا وأنا أعمل في أمريكا أن أولادي كان مطلوب منهم قراءة عدد معين من الكتب طوال العام خارج المنهج المدرسي ثم يختار المدرس أحد هذه الكتب ليقدمه الطالب أمام زملاءه. وأتذكر وأنا أستاذ مساعد هناك أني كان مطلوبًا مني كأحد مهام العمل أن أزور أحد المدارس في المدينة أو الولاية وأقرأ كتابًا أختاره بنفسي لحد فصول هذه المدرسة كنوع من خدمة المجتمع، ولم يكن أنا فقط، بل معظم الاساتذة.
كم أتمنى أن يُسن نطام يضمن القراءة لأنها هي من أكبر الوسائل تأثيرًا لإعمال العقل في هذا العصر المليء بالمعلومات القادمة من مصادر غير موثوق فيها نتيجة لإتاحة استخدام التكنولوجيا بلا رقيب أو عتيد. إن البعد عن القراءة والكتب خاصة يسطح العقل ويجعله مجرد لوح ثلج طبعت عليه كلمات تتلاشي بمجرد شروق شمس الصباح.
د. محمد لبيب سالم
أستاذ علم المناعة كلية العلوم جامعة طنطا
وكاتب وروائي وعضو اتحاد كتاب مصر




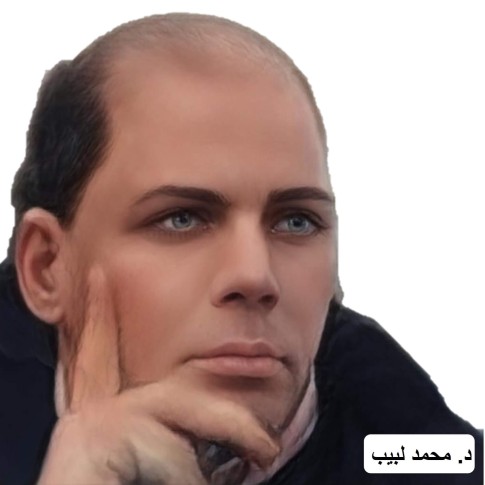












التعليقات